تطورات متلاحقة جرت، خلال الفترة القريبة الماضية، علي المستويين الإقليمي والعالمي. وعلي تنوع القضايا، وتباين التطورات والتفاعلات الجارية، يمكن تلمس بعض القواسم المشتركة التي ميزتها، وصارت ملمحا عاما لها. من أهم تلك القواسم ما يمكن عدّه "نزعة تشاركية" في إدارة الملفات والقضايا، دوليا وإقليميا.
فقد انكسرت، إلي حد بعيد، حالة التفرد بالدور الرئيسي، أو ما يمكن عدّه احتكارا لدور الفاعل والمحرك، سواء في قضايا العالم، أو مجريات الأحداث في الشرق الأوسط. وعند ذكر "الاحتكار"، و"التفرد"، و"الدور المحوري"، تنصرف الأذهان مباشرة إلي الولايات المتحدة الأمريكية، التي كثيرا ما نظر العالم كله إليها كدولة عظمي تتقاسم إدارة العالم ثنائيا مع الاتحاد السوفيتي، ثم كقوة وحيدة تحكم العالم منفردة، منذ سقط القطب الثاني بانهيار الدولة السوفيتية الاتحادية. وبالفعل، لم تكن الولايات المتحدة قوة مهيمنة، بل متفردة، علي المستوي العالمي فقط، بل أيضا في النطاق الإقليمي، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلي مناطق أخري في الكرة الأرضية
غير أن الهيمنة الأمريكية تبدو في حالة اضمحلال متزايدة منذ عدة سنوات، ربما لم تظهر ملامحها في الشرق الأوسط إلا أخيرا بانحسار الدور الأمريكي في توجيه دفة التفاعلات، وإدارة القضايا الإقليمية إلا أن إشارات التراجع علي المستوي العالمي تسبق ذلك بسنوات. وبرزت قوي أخري، وأدوار جديدة لفاعلين دوليين ليسوا جددا، لكن الوزن النسبي ومساحة التأثير الخاصة بكل منهم قد اتسعت، بالتزامن مع ما أفسحه التراجع الأمريكي من مساحة للحركة
والحديث هنا ليس فقط عن "السياسة" بمعناها المباشر من نزاعات، وعلاقات، وتوازنات إقليمية، وإنما يشمل -وربما بالأساس- القدرات الاقتصادية، والدور الذي تلعبه الدول، سواء في إدارة التفاعلات الاقتصادية علي المستوي العالمي، أو التجليات السياسية التي تستند إلي وضعية الدولة وقدراتها الاقتصادية. لذا، لم يكن مستغربا أن تستضيف الصين، مطلع سبتمبر الماضي، قمة مجموعة العشرين. وهي المرة الأولي التي يستضيف فيها العملاق الأصفر حدثا عالميا بهذا المستوي، سواء كان سياسيا أو اقتصاديا
ولم يقتصر الأمر علي دلالة استضافة القمة، بل كان لبكين موقف واضح في مواجهة دعوات الدول الغربية إلي كسر السياسات الحمائية، ورفع مستوي الانفتاح الداخلي علي الاقتصاد العالمي. لذا، فما يبدو من أن قمة العشرين انتهت دون نتائج حقيقية إنما يؤكد أن انعقاد القمة في الصين تجسيد عملي، وليس فقط رمزيا لتوازن جديد للقوة في العالم
وبالتوازي مع هذه الخطوة، يمكن بسهولة ملاحظة أن ثمة انحسارا في الحضور، والتأثير، والفاعلية الخاصة بكل من الاتحاد الأوروبي واليابان. فعلي الأقل، لا تزال الولايات المتحدة بمواقفها وتحركاتها تحتفظ بحضور إعلامي، وتأثير -ولو كان ظاهريا - في السياسة العالمية بمعناها الواسع (السياسي والاقتصادي). بينما تبدو أوروبا منهمكة في التعاطي مع أزمات اللاجئين، وخروج بريطانيا، ومستقبل الاتحاد الأوروبي. واليابان منشغلة بوضع اقتصادي داخلي لم يعد يسمح لها بالالتفات كثيرا إلي مشاكل الخارج
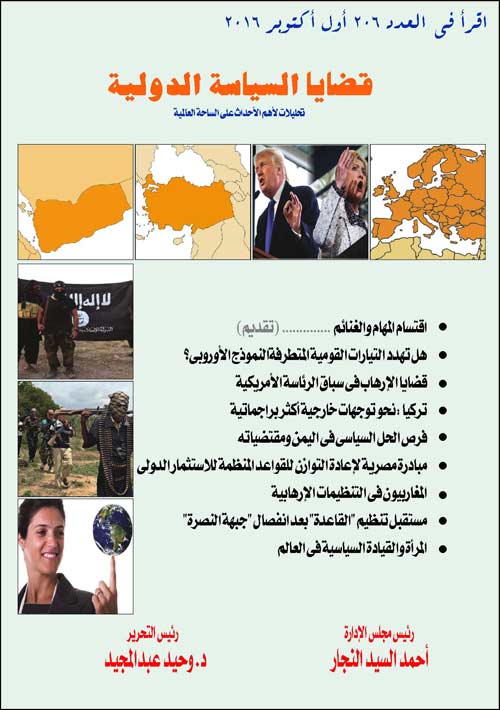
قضايا---داخلي-داخلي
بقية القوي المؤثرة علي المستوي العالمي حالها ليس أفضل كثيرا. فروسيا، التي تتصدر المشهد الإقليمي في الشرق الأوسط سياسيا، وربما عسكريا، تمر بمآزق ومواجهات صعبة اقتصادية بالأساس في الداخل، وسياسية إلي حد ما في الخارج، بدءا من ملف أوكرانيا، وانتهاء بمقتضيات وأعباء التحالف الاستراتيجي مع كل من إيران وسوريا. أما الصين، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، فالأخيرتان في مرحلة استكمال مقومات القوة الكبري، وتحسس الخطي وسط النظام العالمي الشائك. والأولي لا تزال متمسكة بسياستها الانكفائية، مكتفية باجتياح العالم تجاريا، مع الإحجام عن ترجمة قوتها الاقتصادية في تجسيد سياسي صريح
في وضع كهذا، يمكن فهم ما يجري من عمليات "توزيع المهام"، و"اقتسام الأعباء" بين القوي الكبري في العالم، والتي يفترض أن يقابلها بالضرورة عملية موازية من "تبادل المكاسب" القائمة أو المحتملة، أخذا في الحسبان أن ذلك لا يعني بالضرورة توازنا أو عدالة في التوزيع بين القوي العالمية فالوضع لم يبدأ من حالة توازن أصلا، حيث إن الميزان العالمي كان مائلا لما يقرب من عقدين لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي، يبدو الوضع الراهن كأنه عملية إزاحة للقوة الأمريكية لمصلحة القوي الأخري، مع مراعاة اختلاف قدراتها وأوزانها النسبية. ويساعد في ذلك التصور ما تقوم به واشنطن فعليا من انسحاب، وتخل عن دور القائد الوحيد، والقوة المهيمنة إقليميا وعالميا. فيبدو الأمر كأن واشنطن تسلم دفة القيادة إلي دول أخري، بينما هو اتجاه نحو التشاركية، واقتسام المهام والمغانم، فرضته التطورات، خصوصا تصاعد قوة الأطراف الأخري، ولم يكن تنازلا طوعيا من جانب واشنطن
وهناك عديد من الأمثلة علي ذلك المشهد العالمي الآخذ في التبلور، بدءا من الدخول الروسي القوي علي خط أزمات ومشكلات الشرق الأوسط، بل وتقريبا احتلال مقعد القيادة في الأزمة السورية، عسكريا وسياسيا، مرورا بالتفاهمات التي تحاول أوروبا بلورتها وتطبيقها حول قضية اللاجئين، سواء داخل البيت الأوروبي، أو مع الجوار، خصوصا تركيا ودول جنوب المتوسط، وانتهاء بقمة العشرين التي جسدت بوضوح إدراك الدول الكبري -ولو نسبيا- لمخاطر السياسات الحمائية، وضرورة مواجهة بعض المشكلات العابرة للحدود بالتنسيق، والتعاون، والانفتاح المتبادل، بعد أن صار معظم المشكلات الداخلية، ذات البعد الأمني، جرائم عابرة للحدود، تشكل نمطا واحدا متشابها، ينتقل ويمتد من دولة إلي أخري
هذا التوجه التشاركي لا يزال يواجه عقبات كثيرة، بعضها يتعلق بالسياسات الحمائية اقتصاديا، والانكفائية سياسيا التي يتبناها بعض القوي الكبري، والفواعل المؤثرة، خصوصا الصين، وروسيا، والبرازيل إلا أن مقتضيات الواقع، وما تستتبعه موازين القوة، ستفرض نفسها في النهاية علي الجميع. وستجد الدول الكبري، التي كثيرا ما سعت لأن تصبح بالفعل كبري، أن من مصلحتها، إن أرادت الاحتفاظ بقوتها، ومكانتها، وموقعها في النظام العالمي، أن تقبل بالتعاون والتفاعل مع بعضها بعضا، من منطلق الاقتسام، وليس الانقسام